 youyou17
youyou17
عدد الرسائل : 2077
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 12/05/2009
 محمد صلى الله عليه وسلم سكان المدينة وأحوالهم عند الهجرة
محمد صلى الله عليه وسلم سكان المدينة وأحوالهم عند الهجرة
الإثنين 24 أغسطس 2009, 17:19
لم يكن معنى الهجرة التخلص والفرار من
الفتنة فحسب، بل كانت الهجرة تعنى مع هذا تعاونًا على إقامة مجتمع جديد في
بلد آمن، ولذلك أصبح فرضًا على كل مسلم يقدر على الهجرة أن يهاجر ويسهم في
بناء هذا الوطن الجديد، ويبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه.
ولاشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام والقائد والهادى في بناء هذا المجتمع، وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع.
والذين قابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا على ثلاثة
أصناف، يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافًا واضحًا، وكان
يواجه بالنسبة إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها
بالنسبة إلى الآخر.
وهذه الأصناف الثلاثة هي:
1 ـ أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم.
2 ـ المشركون الذين لم يؤمنوا بعد، وهم من صميم قبائل المدينة.
3 ـ اليهــود.
أ ـ والمسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة
بالنسبة إليهم كانت تختلف تمامًا عن الظروف التي مروا بها في مكة، فهم في
مكة وإن كانت تجمعهم كلمة جامعة وكانوا يستهدفون هدفًا واحدًا، إلا أنهم
كانوا متفرقين في بيوتات شتى، مقهورين أذلاء مطرودين، لم يكن لهم من الأمر
شيء، وإنما كان الأمر بيد أعدائهم في الدين، فلم يكن هؤلاء المسلمون
يستطيعون أن ينشئوا مجتمعًا إسلاميًا جديدًا بمواده التي لا يستغنى عنها
أي مجتمع إنسإني في العالم؛ ولذلك نرى السور المكية تقتصر على تفصيل
المبادئ الإسلامية، وعلى التشريعات التي يمكن العمل بها لكل فرد وحده،
وعلى الترغيب في البر والخير ومكارم الأخلاق والترهيب عن الرذائل
والدنايا.
أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم، ولم يكن يسيطر
عليهم أحد من الناس، وهذا يعنى أنهم قد آن لهم أن يواجهوا مسائل الحضارة
والعمران، والمعيشة والاقتصاد، والسياسة والحكومة، والسلم والحرب، وأن
تفصل لهم مسائل الحلال والحرام، والعبادة والأخلاق، وما إلى ذلك من شئون
الحياة.
أي آن للمسلمين أن يكونوا مجتمعًا إسلاميًا يختلف في جميع مراحل الحياة عن
المجتمع الجاهلي، ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العالم الإنساني، ويكون
ممثلًا للدعوة الإسلامية التي عانى لها المسلمون ألوانًا من النكال
والعذاب طيلة عشر سنوات.
ولا يخفي أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد،
أو شهر واحد، أو سنة واحدة، بل لابد له من زمن طويل يتكامل فيه التشريع
والتقنين والتربية والتثقيف والتدريب والتنفيذ شيئًا فشيئًا، وكان الله
كفيلًا بهذا التشريع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا بتنفيذه
والإرشاد إليه، وبتربية المسلمين وتزكيتهم وفق ذلك {هُوَ الَّذِي بَعَثَ
فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [الجمعة:
2].
وكان الصحابة رضي الله عنهم مقبلين عليه بقلوبهم،يتحلون بأحكامه،ويستبشرون
بها {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا}
[الأنفال: 2]. وليس تفصيل هذه المسائل كلها من مباحث موضوعنا،
فنقتصر منها على قدر الحاجة.
وكان هذا أعظم ما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين،
وهو الهدف الأسمى والمطلب النبيل المقصود من الدعوة الإسلامية والرسالة
المحمدية، ومعلوم أنه ليس بقضية طارئة تطلب الاستعجال، بل هي قضية أصيلة
تحتاج إلى آجال. نعم، كانت هناك قضايا طارئة تطلب الحل العاجل والحكيم،
أهمها أن المسلمين كانوا على قسمين:
قسم كانوا في أرضهم وديارهم وأموالهم، لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل
وهو آمن في سِرْبِـه، وهم الأنصار، وكان بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن
منذ أمد بعيد.
وقسم آخر فاتهم كل ذلك، ونجوا بأنفسهم إلى المدينة، وهم المهاجرون، فلم
يكن لهم ملجأ يأوون إليه، ولا عمل يكسبون به ما يسد حاجتهم، ولا مال
يبلغون به قَوَامًا من العيش، وكان عدد هؤلاء اللاجئين غير قليل، ثم كانوا
يزيدون يومًا فيوما؛ إذ كان قد أوذن بالهجرة لكل من آمن بالله ورسوله.
ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة فتزعزع ميزانها الاقتصادى، وفي
هذه الساعة الحرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة اقتصادية،
قَلَّت لأجلها المستوردات وتفاقمت الظروف.
ب ـ أما القوم الثاني ـ وهم المشركون من صميم قبائل المدينة ـ فلم تكن لهم
سيطرة على المسلمين، وكان منهم من يتخالجه الشكوك ويتردد في ترك دين
الآباء، ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين، ولم تمض
عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله.
وكان فيهم من يبطن شديد الإحن والعداوة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم
والمسلمين، ولكن لم يكن يستطيع أن يناوئهم، بل كان مضطرًا إلى إظهار الودّ
والصفاء نظرًا إلى الظروف، وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي، فقد كانت
الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد حرب بُعَاث ـ ولم يكونوا اجتمعوا
على سيادة أحد قبله ـ وكانوا قد نظموا له الخَرْز، ليُتَوِّجُوه
ويُمَلّكُوه، وكان على وشك أن يصير ملكًا على أهل المدينة إذ بوغت بمجىء
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصراف قومه عنه إليه، فكان يرى أنه
استلبه الملك، فكان يبطن شديد العداوة ضده، ولما رأي أن الظروف لا تساعده
على شركه، وأنه سوف يحرم بقايا العز والشرف وما يترتب عليهما من منافع
الحياة الدنيا أظهر الإسلام بعد بدر، ولكن بقى مستبطنًا الكفر، فكان لا
يجد مجالًا يكيد فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين إلا
ويأتيه، وكان أصحابه ـ من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه ـ
يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه، وربما كانوا يتخذون بعض الشباب وسذجة
المسلمين عميلًا لتنفيذ خطتهم من حيث لا يشعر.
جـ ـ أما القوم الثالث ـ وهم اليهود ـ فإنهم كانوا قد انحازوا إلى الحجاز
زمن الاضطهاد الأشورى والروماني كما أسلفنا، وكانوا في الحقيقة عبرانيين،
ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز اصطبغوا بالصبغة العربية في الزى واللغة
والحضارة، حتى صارت أسماؤهم وأسماء قبائلهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين
العرب علاقة الزواج والصهر، إلا أنهم احتفظوا بعصبيتهم الجنسية، ولم
يندمجوا في العرب قطعًا، بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم الإسرائيلية ـ
اليهودية ـ وكانوا يحتقرون العرب احتقارًا بالغًا وكانوا يرون أن أموال
العرب مباحة لهم، يأكلونها كيف شاءوا، قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم
مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا
دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا
فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} [آل عمران: 75]. ولم يكونوا متحمسين
في نشر دينهم، وإنما جل بضاعتهم الدينية هي: الفأل والسحر والنفث
والرقية وأمثالها، وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة
روحانية.
وكانوا مَهَرَةً في فنون الكسب والمعيشة، فكانت في أيديهم تجارة الحبوب
والتمر والخمر والثياب، كانوا يستوردون الثياب والحبوب والخمر، ويصدرون
التمر، وكانت لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فكانوا يأخذون المنافع
من عامة العرب أضعافًا مضاعفة، ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك، بل كانوا
أكالين للربا، يعطون القروض الطائلة لشيوخ العرب وساداتهم؛ ليكسبوا بها
مدائح الشعراء والسمعة الحسنة بين الناس بعد إنفاقها من غير جدوى ولا
طائلة، وكانوا يرتهنون لها أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم، ثم لا
يلبثون إلا أعوامًا حتى يتملكونها.
وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد؛ يلقون العداوة والشحناء بين
القبائل العربية المجاورة، ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره
تلك القبائل، فكانت تتطاحن في حروب، ولم تكد تنطفئ نيرانها حتى تتحرك
أنامل اليهود مرة أخرى لتؤججها من جديد. فإذا تم لهم ذلك جلسوا على حياد
يرون نتائج هذا التحريض والإغراء، ويستلذون بما يحل بهؤلاء المساكين ـ
العرب ـ من التعاسة والبوار، ويزودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا
عن الحرب لعسر النفقة. وبهذا التدبير كانوا يحصلون على فائدتين
كبيرتين: هما الاحتفاظ على كيانهم اليهودى، وإنفاق سوق الربا؛ ليأكلوه
أضعافًا مضاعفة، ويكسبوا ثروات طائلة.
وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة:
1ـ بنو قَيْنُقَاع : وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينة.
2ـ بنو النَّضِير: وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم بضواحى المدينة.
3ـ بنو قُرَيْظة: وكانوا حلفاء الأوس، وكانت ديارهم بضواحى المدينة.
وهذه القبائل هي التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج منذ أمد بعيد، وقد ساهمت بأنفسها في حرب بُعَاث، كل مع حلفائها.
وطبعًا فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض
والحقد؛ فالرسول لم يكن من أبناء جنسهم حتى يُسَكِّن جَأْشَ عصبيتهم
الجنسية التي كانت مسيطرة على نفسياتهم وعقليتهم، ودعوة الإسلام لم تكن
إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب، وتطفئ نار العداوة والبغضاء، وتدعو
إلى التزام الأمانة في كل الشئون، وإلى التقيد بأكل الحلال من طيب
الأموال، ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتآلف فيما بينها، وحينئذ
لابد من أن تفلت من براثن اليهود، فيفشل نشاطهم التجارى، ويحرمون أموال
الربا الذي كانت تدور عليه رحى ثروتهم، بل يحتمل أن تتيقظ تلك القبائل،
فتدخل في حسابها الأموال الربوية التي أخذتها اليهود، وتقوم بإرجاع أرضها
وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا.
كان اليهود يدخلون كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول
الاستقرار في يثرب؛ ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام، وضد رسول
الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل يثرب، وإن كانوا لم يتجاسروا على
إظهارها إلا بعد حين.
ويظهر ذلك جليًا بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها
قال ابن إسحاق: حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحَبَّ
ولد أبي إليه، وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذإني
دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء
في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي؛ حيى بن أخطب، وعمى أبو ياسر بن أخطب
مُغَلِّسِين، قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس، قالت: فأتيا
كَالَّيْن كسلانين ساقطين يمشيان الهُوَيْنَى. قالت: فهششت إليهما كما
كنت أصنع، فوالله ما التفت إلىَّ واحد منهما، مع ما بهما من الغم.
قالت: وسمعت عمى أبا ياسر، وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟
قال: نعم والله، قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم، قال: فما في
نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت.
ويشهد بذلك أيضًا ما رواه البخاري في إسلام عبد الله بن سَلاَم رضي الله
عنه فقد كان حبرًا من فطاحل علماء اليهود، ولما سمع بمقدم رسول الله صلى
الله عليه وسلم المدينة في بني النجار جاءه مستعجلًا، وألقى إليه أسئلة لا
يعلمها إلا نبى، ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم عليها آمن به ساعته
ومكانه، ثم قال له: إن اليهود قوم بُهْتٌ، إن علموا بإسلامي قبل أن
تسألهم بَهَتُونِى عندك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت
اليهود، ودخل عبد الله بن سلام البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: [أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟] قالوا: أعلمنا وابن
أعلمنا، وأخيرنا وابن أخيرنا ـ وفي لفظ: سيدنا وابن سيدنا. وفي لفظ
آخر: خيرنا وابن خيرنا، وأفضلنا وابن أفضلنا ـ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: [أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟] فقالوا: أعاذه الله من
ذلك [مرتين أو ثلاثا]، فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله
إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، قالوا: شرّنا وابن شرّنا، ووقعوا
فيه. وفي لفظ: فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا
إله إلا هو، إنكم لتعلمون أنه رسول الله، وأنه جاء بحق. فقالوا:
كذبت.
وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود في أول يوم دخل فيه المدينة.
وهذه هي الظروف والقضايا الداخلية التي واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزل بالمدينة.
أما من ناحية الخارج فكان يحيط بها من يدين بدين قريش، وكانت قريش ألـد
عـدو للإسلام والمسلمين، جربت عليهم طوال عشرة أعوام ـ حينما كان المسلمون
تحت أيديها ـ كل أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة والتعذيب، والمقاطعة
والتجويع، وأذاقتهم التنكيلات والويلات، وشنت عليهم حربًا نفسية مضنية مع
دعاية واسعة منظمة، ولما هاجر المسلمون إلى المدينة صادرت أرضهم وديارهم
وأموالهم، وحالت بينهم وبين أزواجهم وذرياتهم، بل حبست وعذبت من قدرت
عليه، ولم تقتصر على هذا، بل تآمرت على الفتك بصاحب الدعوة صلى الله عليه
وسلم، والقضاء عليه وعلى دعوته، ولم تَأْلُ جهدًا في تنفيذ هذه
المؤامرة. فكان من الطبيعى جدًا، حينما نجا المسلمون منها إلى أرض تبعد
نحو خمسمائة كيلو متر، أن تقوم بدورها السياسى والعسكرى، لما لها من
الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب بصفتها ساكنة الحرم
ومجاورة بيت الله وسدنته، وتغرى غيرها من مشركي الجزيرة ضد أهل المدينة،
وفعلًا قامت بذلك كله حتى صارت المدينة محفوفة بالأخطار، وفي شبه مقاطعة
شديدة قَلَّتْ لأجلها المستوردات، في حين كان عدد اللاجئين إليها يزيد
يومًا بعد يوم، وبذلك كانت [حالة الحرب] قائمة بين هؤلاء الطغاة من
أهل مكة ومن دان دينهم، وبين المسلمين في وطنهم الجديد.
وكان من حق المسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة كما صودرت أموالهم،
وأن يديلوا عليهم من التنكيلات بمثل ما أدالوا بها، وأن يقيموا في سبيل
حياتهم العراقيل كما أقاموها في سبيل حياة المسلمين، وأن يكيلوا لهؤلاء
الطغاة صاعًا بصاع حتى لا يجدوا سبيلًا لإبادة المسلمين واستئصال
خضرائهم.
وهذه هي القضايا والمشاكل الخارجية التي واجهها رسول الله صلى الله عليه
وسلم بعدما ورد المدينة، وكان عليه أن يعالجها بحكمة بالغة حتى يخرج منها
مكللًا بالنجاح.
وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالجة كل القضايا أحسن قيام،
بتوفيق من الله وتأييده، فعامل كل قوم بما كانوا يستحقونه من الرأفة
والرحمة أو الشدة والنكال،وذلك بجانب قيامه بتزكية النفوس وتعليم الكتاب
والحكمة، ولا شك أن جانب التزكية والتعليم والرأفة والرحمة كان غالبًا على
جانب الشدة والعنت ـ حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات
الفتنة فحسب، بل كانت الهجرة تعنى مع هذا تعاونًا على إقامة مجتمع جديد في
بلد آمن، ولذلك أصبح فرضًا على كل مسلم يقدر على الهجرة أن يهاجر ويسهم في
بناء هذا الوطن الجديد، ويبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه.
ولاشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام والقائد والهادى في بناء هذا المجتمع، وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع.
والذين قابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا على ثلاثة
أصناف، يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافًا واضحًا، وكان
يواجه بالنسبة إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها
بالنسبة إلى الآخر.
وهذه الأصناف الثلاثة هي:
1 ـ أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم.
2 ـ المشركون الذين لم يؤمنوا بعد، وهم من صميم قبائل المدينة.
3 ـ اليهــود.
أ ـ والمسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة
بالنسبة إليهم كانت تختلف تمامًا عن الظروف التي مروا بها في مكة، فهم في
مكة وإن كانت تجمعهم كلمة جامعة وكانوا يستهدفون هدفًا واحدًا، إلا أنهم
كانوا متفرقين في بيوتات شتى، مقهورين أذلاء مطرودين، لم يكن لهم من الأمر
شيء، وإنما كان الأمر بيد أعدائهم في الدين، فلم يكن هؤلاء المسلمون
يستطيعون أن ينشئوا مجتمعًا إسلاميًا جديدًا بمواده التي لا يستغنى عنها
أي مجتمع إنسإني في العالم؛ ولذلك نرى السور المكية تقتصر على تفصيل
المبادئ الإسلامية، وعلى التشريعات التي يمكن العمل بها لكل فرد وحده،
وعلى الترغيب في البر والخير ومكارم الأخلاق والترهيب عن الرذائل
والدنايا.
أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم، ولم يكن يسيطر
عليهم أحد من الناس، وهذا يعنى أنهم قد آن لهم أن يواجهوا مسائل الحضارة
والعمران، والمعيشة والاقتصاد، والسياسة والحكومة، والسلم والحرب، وأن
تفصل لهم مسائل الحلال والحرام، والعبادة والأخلاق، وما إلى ذلك من شئون
الحياة.
أي آن للمسلمين أن يكونوا مجتمعًا إسلاميًا يختلف في جميع مراحل الحياة عن
المجتمع الجاهلي، ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العالم الإنساني، ويكون
ممثلًا للدعوة الإسلامية التي عانى لها المسلمون ألوانًا من النكال
والعذاب طيلة عشر سنوات.
ولا يخفي أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد،
أو شهر واحد، أو سنة واحدة، بل لابد له من زمن طويل يتكامل فيه التشريع
والتقنين والتربية والتثقيف والتدريب والتنفيذ شيئًا فشيئًا، وكان الله
كفيلًا بهذا التشريع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا بتنفيذه
والإرشاد إليه، وبتربية المسلمين وتزكيتهم وفق ذلك {هُوَ الَّذِي بَعَثَ
فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [الجمعة:
2].
وكان الصحابة رضي الله عنهم مقبلين عليه بقلوبهم،يتحلون بأحكامه،ويستبشرون
بها {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا}
[الأنفال: 2]. وليس تفصيل هذه المسائل كلها من مباحث موضوعنا،
فنقتصر منها على قدر الحاجة.
وكان هذا أعظم ما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين،
وهو الهدف الأسمى والمطلب النبيل المقصود من الدعوة الإسلامية والرسالة
المحمدية، ومعلوم أنه ليس بقضية طارئة تطلب الاستعجال، بل هي قضية أصيلة
تحتاج إلى آجال. نعم، كانت هناك قضايا طارئة تطلب الحل العاجل والحكيم،
أهمها أن المسلمين كانوا على قسمين:
قسم كانوا في أرضهم وديارهم وأموالهم، لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل
وهو آمن في سِرْبِـه، وهم الأنصار، وكان بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن
منذ أمد بعيد.
وقسم آخر فاتهم كل ذلك، ونجوا بأنفسهم إلى المدينة، وهم المهاجرون، فلم
يكن لهم ملجأ يأوون إليه، ولا عمل يكسبون به ما يسد حاجتهم، ولا مال
يبلغون به قَوَامًا من العيش، وكان عدد هؤلاء اللاجئين غير قليل، ثم كانوا
يزيدون يومًا فيوما؛ إذ كان قد أوذن بالهجرة لكل من آمن بالله ورسوله.
ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة فتزعزع ميزانها الاقتصادى، وفي
هذه الساعة الحرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة اقتصادية،
قَلَّت لأجلها المستوردات وتفاقمت الظروف.
ب ـ أما القوم الثاني ـ وهم المشركون من صميم قبائل المدينة ـ فلم تكن لهم
سيطرة على المسلمين، وكان منهم من يتخالجه الشكوك ويتردد في ترك دين
الآباء، ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين، ولم تمض
عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله.
وكان فيهم من يبطن شديد الإحن والعداوة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم
والمسلمين، ولكن لم يكن يستطيع أن يناوئهم، بل كان مضطرًا إلى إظهار الودّ
والصفاء نظرًا إلى الظروف، وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي، فقد كانت
الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد حرب بُعَاث ـ ولم يكونوا اجتمعوا
على سيادة أحد قبله ـ وكانوا قد نظموا له الخَرْز، ليُتَوِّجُوه
ويُمَلّكُوه، وكان على وشك أن يصير ملكًا على أهل المدينة إذ بوغت بمجىء
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصراف قومه عنه إليه، فكان يرى أنه
استلبه الملك، فكان يبطن شديد العداوة ضده، ولما رأي أن الظروف لا تساعده
على شركه، وأنه سوف يحرم بقايا العز والشرف وما يترتب عليهما من منافع
الحياة الدنيا أظهر الإسلام بعد بدر، ولكن بقى مستبطنًا الكفر، فكان لا
يجد مجالًا يكيد فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين إلا
ويأتيه، وكان أصحابه ـ من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه ـ
يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه، وربما كانوا يتخذون بعض الشباب وسذجة
المسلمين عميلًا لتنفيذ خطتهم من حيث لا يشعر.
جـ ـ أما القوم الثالث ـ وهم اليهود ـ فإنهم كانوا قد انحازوا إلى الحجاز
زمن الاضطهاد الأشورى والروماني كما أسلفنا، وكانوا في الحقيقة عبرانيين،
ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز اصطبغوا بالصبغة العربية في الزى واللغة
والحضارة، حتى صارت أسماؤهم وأسماء قبائلهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين
العرب علاقة الزواج والصهر، إلا أنهم احتفظوا بعصبيتهم الجنسية، ولم
يندمجوا في العرب قطعًا، بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم الإسرائيلية ـ
اليهودية ـ وكانوا يحتقرون العرب احتقارًا بالغًا وكانوا يرون أن أموال
العرب مباحة لهم، يأكلونها كيف شاءوا، قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم
مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا
دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا
فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} [آل عمران: 75]. ولم يكونوا متحمسين
في نشر دينهم، وإنما جل بضاعتهم الدينية هي: الفأل والسحر والنفث
والرقية وأمثالها، وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة
روحانية.
وكانوا مَهَرَةً في فنون الكسب والمعيشة، فكانت في أيديهم تجارة الحبوب
والتمر والخمر والثياب، كانوا يستوردون الثياب والحبوب والخمر، ويصدرون
التمر، وكانت لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فكانوا يأخذون المنافع
من عامة العرب أضعافًا مضاعفة، ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك، بل كانوا
أكالين للربا، يعطون القروض الطائلة لشيوخ العرب وساداتهم؛ ليكسبوا بها
مدائح الشعراء والسمعة الحسنة بين الناس بعد إنفاقها من غير جدوى ولا
طائلة، وكانوا يرتهنون لها أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم، ثم لا
يلبثون إلا أعوامًا حتى يتملكونها.
وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد؛ يلقون العداوة والشحناء بين
القبائل العربية المجاورة، ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره
تلك القبائل، فكانت تتطاحن في حروب، ولم تكد تنطفئ نيرانها حتى تتحرك
أنامل اليهود مرة أخرى لتؤججها من جديد. فإذا تم لهم ذلك جلسوا على حياد
يرون نتائج هذا التحريض والإغراء، ويستلذون بما يحل بهؤلاء المساكين ـ
العرب ـ من التعاسة والبوار، ويزودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا
عن الحرب لعسر النفقة. وبهذا التدبير كانوا يحصلون على فائدتين
كبيرتين: هما الاحتفاظ على كيانهم اليهودى، وإنفاق سوق الربا؛ ليأكلوه
أضعافًا مضاعفة، ويكسبوا ثروات طائلة.
وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة:
1ـ بنو قَيْنُقَاع : وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينة.
2ـ بنو النَّضِير: وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم بضواحى المدينة.
3ـ بنو قُرَيْظة: وكانوا حلفاء الأوس، وكانت ديارهم بضواحى المدينة.
وهذه القبائل هي التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج منذ أمد بعيد، وقد ساهمت بأنفسها في حرب بُعَاث، كل مع حلفائها.
وطبعًا فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض
والحقد؛ فالرسول لم يكن من أبناء جنسهم حتى يُسَكِّن جَأْشَ عصبيتهم
الجنسية التي كانت مسيطرة على نفسياتهم وعقليتهم، ودعوة الإسلام لم تكن
إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب، وتطفئ نار العداوة والبغضاء، وتدعو
إلى التزام الأمانة في كل الشئون، وإلى التقيد بأكل الحلال من طيب
الأموال، ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتآلف فيما بينها، وحينئذ
لابد من أن تفلت من براثن اليهود، فيفشل نشاطهم التجارى، ويحرمون أموال
الربا الذي كانت تدور عليه رحى ثروتهم، بل يحتمل أن تتيقظ تلك القبائل،
فتدخل في حسابها الأموال الربوية التي أخذتها اليهود، وتقوم بإرجاع أرضها
وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا.
كان اليهود يدخلون كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول
الاستقرار في يثرب؛ ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام، وضد رسول
الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل يثرب، وإن كانوا لم يتجاسروا على
إظهارها إلا بعد حين.
ويظهر ذلك جليًا بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها
قال ابن إسحاق: حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحَبَّ
ولد أبي إليه، وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذإني
دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء
في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي؛ حيى بن أخطب، وعمى أبو ياسر بن أخطب
مُغَلِّسِين، قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس، قالت: فأتيا
كَالَّيْن كسلانين ساقطين يمشيان الهُوَيْنَى. قالت: فهششت إليهما كما
كنت أصنع، فوالله ما التفت إلىَّ واحد منهما، مع ما بهما من الغم.
قالت: وسمعت عمى أبا ياسر، وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟
قال: نعم والله، قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم، قال: فما في
نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت.
ويشهد بذلك أيضًا ما رواه البخاري في إسلام عبد الله بن سَلاَم رضي الله
عنه فقد كان حبرًا من فطاحل علماء اليهود، ولما سمع بمقدم رسول الله صلى
الله عليه وسلم المدينة في بني النجار جاءه مستعجلًا، وألقى إليه أسئلة لا
يعلمها إلا نبى، ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم عليها آمن به ساعته
ومكانه، ثم قال له: إن اليهود قوم بُهْتٌ، إن علموا بإسلامي قبل أن
تسألهم بَهَتُونِى عندك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت
اليهود، ودخل عبد الله بن سلام البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: [أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟] قالوا: أعلمنا وابن
أعلمنا، وأخيرنا وابن أخيرنا ـ وفي لفظ: سيدنا وابن سيدنا. وفي لفظ
آخر: خيرنا وابن خيرنا، وأفضلنا وابن أفضلنا ـ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: [أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟] فقالوا: أعاذه الله من
ذلك [مرتين أو ثلاثا]، فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله
إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، قالوا: شرّنا وابن شرّنا، ووقعوا
فيه. وفي لفظ: فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا
إله إلا هو، إنكم لتعلمون أنه رسول الله، وأنه جاء بحق. فقالوا:
كذبت.
وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود في أول يوم دخل فيه المدينة.
وهذه هي الظروف والقضايا الداخلية التي واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزل بالمدينة.
أما من ناحية الخارج فكان يحيط بها من يدين بدين قريش، وكانت قريش ألـد
عـدو للإسلام والمسلمين، جربت عليهم طوال عشرة أعوام ـ حينما كان المسلمون
تحت أيديها ـ كل أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة والتعذيب، والمقاطعة
والتجويع، وأذاقتهم التنكيلات والويلات، وشنت عليهم حربًا نفسية مضنية مع
دعاية واسعة منظمة، ولما هاجر المسلمون إلى المدينة صادرت أرضهم وديارهم
وأموالهم، وحالت بينهم وبين أزواجهم وذرياتهم، بل حبست وعذبت من قدرت
عليه، ولم تقتصر على هذا، بل تآمرت على الفتك بصاحب الدعوة صلى الله عليه
وسلم، والقضاء عليه وعلى دعوته، ولم تَأْلُ جهدًا في تنفيذ هذه
المؤامرة. فكان من الطبيعى جدًا، حينما نجا المسلمون منها إلى أرض تبعد
نحو خمسمائة كيلو متر، أن تقوم بدورها السياسى والعسكرى، لما لها من
الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب بصفتها ساكنة الحرم
ومجاورة بيت الله وسدنته، وتغرى غيرها من مشركي الجزيرة ضد أهل المدينة،
وفعلًا قامت بذلك كله حتى صارت المدينة محفوفة بالأخطار، وفي شبه مقاطعة
شديدة قَلَّتْ لأجلها المستوردات، في حين كان عدد اللاجئين إليها يزيد
يومًا بعد يوم، وبذلك كانت [حالة الحرب] قائمة بين هؤلاء الطغاة من
أهل مكة ومن دان دينهم، وبين المسلمين في وطنهم الجديد.
وكان من حق المسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة كما صودرت أموالهم،
وأن يديلوا عليهم من التنكيلات بمثل ما أدالوا بها، وأن يقيموا في سبيل
حياتهم العراقيل كما أقاموها في سبيل حياة المسلمين، وأن يكيلوا لهؤلاء
الطغاة صاعًا بصاع حتى لا يجدوا سبيلًا لإبادة المسلمين واستئصال
خضرائهم.
وهذه هي القضايا والمشاكل الخارجية التي واجهها رسول الله صلى الله عليه
وسلم بعدما ورد المدينة، وكان عليه أن يعالجها بحكمة بالغة حتى يخرج منها
مكللًا بالنجاح.
وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالجة كل القضايا أحسن قيام،
بتوفيق من الله وتأييده، فعامل كل قوم بما كانوا يستحقونه من الرأفة
والرحمة أو الشدة والنكال،وذلك بجانب قيامه بتزكية النفوس وتعليم الكتاب
والحكمة، ولا شك أن جانب التزكية والتعليم والرأفة والرحمة كان غالبًا على
جانب الشدة والعنت ـ حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى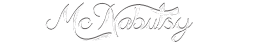
 الرئيسية
الرئيسية
